 أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا  الإهداءات الإهداءات | |
| الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
 « آخـــر الــمــواضــيــع » « آخـــر الــمــواضــيــع » |
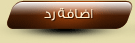 |
| كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 2 | المشاهدات | 745 |  | |  | |  | انشر الموضوع |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح التقليد كما يكون في الجزئيات، فإنه يكون أيضًا في البدع؛ فقد يقلِّد العاميُّ ومَن في حكمه صاحب بدعة، فيُحسن به الظن ويثق به، لا سيما مع نقص علمه وقلة فقهه، وقد يقلده عالمًا بخطئه؛ عنادًا واستكبارًا، وسنبين في هذا المطلب رأي الشَّاطبي في حكم التقليد في البدع بنوعيه. رأي الشَّاطبي: لا يخفى رأي الشَّاطبي في البدع في الجملة، فهو ممن وقف أمامها موقفًا صريحًا، منتهجًا نهج السلف، مرتسمًا هدي خير القرون؛ ولذا لا غرابة أن يرى الشَّاطبي حرمة التقليد في البدع، فلا يجوز عنده التقليد في البدع بحال. ولما أن كان مستحسنو البدع يتمظهرون بمظاهر العبادة والتزهد والانقطاع عن الخلق، فلا غرابة أن يُغَرَّ بهم كثير من العوام، وأنصاف العوام، فيتمثلوا بآرائهم، ويحسنوا الظن بهم[1]، ولما أن كان المبتدع مما لا شك في تأثيمه، فهل من قلد المبتدع في بدعته كذلك أو لا؟ وقد أجاب الشَّاطبي على ذلك بجواب مفصل، ووضحه بالأمثلة، وتفصيل ذلك أن المقلد لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون محصلًا لشيء من العلم، وهو من لم يستنبط بنفسه، وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكنه أقر بالشبهة واستصوبها، ودعا إليها، حتى خالط حبُّها شِغاف قلبه، فعادَى ووالى من أجلها، وصاحب هذه الحالة يتنوع؛ فهو قد يستدل على بدعته كاستدلال من قلده، إما إجمالًا أو تفصيلًا. قال الشَّاطبي: "وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال، ولو على أعمِّ ما يكون؛ فقد يلحق بمن نظر في الشبهة، وإن كان عاميًّا؛ لأنه عرض للاستدلال، وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجُمْلي مبلغ من استدل على التفصيل، وفرق بينهما في التمثيل"[2]. ووجه الفرق بينهما كما قال الشَّاطبي: "أن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها، حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلَّد وانقطع، أو خرج إلى ما لا يُعقَل، وأما الثاني فحسَّن الظن بصاحب البدعة، فتبِعه، ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به، إلا تحسين الظن بالمبتدع خاصة، وهذا القسم في العوام كثيرٌ"[3]. ومثَّل الشَّاطبي على الأول - وهو من استدل على بدعة مقلده بالدليل التفصيلي - بحال حمدان بن قرمط، الذي تنسب له القرامطة[4]؛ فإنه كان رجلًا كوفيًّا مائلًا إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة الباطنية، وهو متوجه إلى قريته، وبين يديه بقر يسوقه، فقال له حمدان، وهو لا يعرفه: "أراك سافرت عن موضع بعيد، فأين مقصدك؟"، فذكر موضعًا هو قرية حمدان، فقال له حمدان: "اركب بقرة من هذا البقر لتستريح به عن تعب المشي"، فلما رأى هذا الداعية حمدان مائلًا إلى الديانة، أتاه من هذا الباب، وقال: "إني لم أؤمر بذلك"، فقال له: "وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟!"، فقال: "نعم"، فقال حمدان: "وبأمر من تعمل؟!"، فأجابه: "بأمر مالكي ومالكك، ومن له الدنيا والآخرة"، قال: "ذلك هو رب العالمين"، قال: "صدقت، ولكن الله يهَب مُلكه من يشاء"، قال: "وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟"، قال: "أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب"، فقال له حمدان: "أنقذني، أنقذك الله، وأفِضْ عليَّ من العلم ما تحييني به، فما أشد احتياجي لمثل ما ذكرت!"، فقال له: "ما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه"، فقال: "فما عهدك فاذكره؛ فإنني ملتزم له"، فقال: "أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسك وميثاقك ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك، ولا تفشي سري أيضًا"، فالتزم حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه، واستجاب له في جميع ما ادعاه، ثم انتدب للدعوة، وصار أصلًا من أصول هذه الطريقة[5]. ومثَّل الشَّاطبي على الثاني: بما حكاه الله في قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [المائدة: 104]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: 72 - 74]. وحَكَى أنه كان في أعلى صعيد مصر من القبط ممن يظهر دِين النصرانية، وكان يُشار إليه بالعلم والفهم، فبلغ خبرُه أحمدَ بن طولون، فاستحضره، وسأله عن أشياء كثيرة، مِن جملتها أنه أمر في بعض الأيام، وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية، فسألوه عن ذلك، فقال: "دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية تدفعها العقول، وتنفِر منها النفوس لتباينها وتضادها، لا نظر يقويها، ولا جدل يصححها، ولا برهان يعفيها من العقل والحس عند أهل التأمل فيها والفحص عنها، ورأيت مع ذلك أممًا كثيرة، وملوكًا عظيمة، ذوي معرفة، وحُسن سياسة، وعقول راجحة، قد انقادوا إليها وتدينوا بها، مع ما ذكرت من تناقضها في العقل، فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا بدلائلَ شاهدوها وآيات ومعجزات عرَفوها أوجب انقيادهم إليها، والتدين بها"، فقال له السائل: "وما التضاد الذي فيها؟"، فقال: "وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟، منها قولهم بأن الثلاثة واحد، وأن الواحد ثلاثة، ووصفهم للأقانيم[6] والجوهر[7]، وهو الثالوثي، وهل الأقانيم في أنفسها قادرة عالمة أو لا؟، وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدَث، وما جرى في ولادته وصلبه وقتله، وهل في التشنيع أكبر وأفحش مِن إله صُلب وبُصق في وجهه ووُضع على رأسه إكليل الشوك، وضرب رأسه بالقضيب، وسمرت قدماه، ونخز بالأسنة والخشب جنباه، وطلب الماء فسقي الخل من بطيخ الحنظل؟!"، فأمسكوا عن مناظرته لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده[8]. ويفهم من كلام الشَّاطبي أن صاحب هذا القسم آثم لتفريطه؛ فهو جعله مثل الأول، إلا أنه أضعف منه استدلالًا، وهو عالة عليه في الاستنباط[9]. وهذا الصنف ممن يستدل على بدعته يطلق عليه لفظ الابتداع، وهو من أهل البدع والأهواء؛ لأنه يردُّ ما خالف مذهبه، ويتعصب له، ويستدل بشبهة إجمالية أو تفصيلية، وذلك هو عين اتباع الهوى، وهو المذموم، قال الشَّاطبي: "وعليه يحصل الإثم؛ فإن من كان مسترشدًا مال إلى الحق حيث وجده، ولم يردَّه، وهو المعتاد في طالب الحق"[10]. الحالة الثانية: من حالات مقلدي المبتدع -: وهو أن يكون المقلد عاميًّا صِرفًا؛ فهو يقلد غيره على البراءة الأصلية. وهذا لا يخلو: إما أن يكون ثم مَن هو أَولى ممن قلده واتبعه أم لا؟ فإن كان العامي قد اتبع هذا المبتدع، مع أن هناك مَن هو أولى منه، فهو آثم في هذه الحالة؛ لأنه مفرِّط فيما وجب عليه؛ إذ يمكنه معرفةُ أن مَن تركه أولى ممن قلده عن طريق سماعه من الآخرين، أو تعظيم الناس لمن تركه، أو نحو ذلك مما فيه تمييز بينهما. قال الشَّاطبي: "أن يكون ثَمَّ مَن هو أولى بالتقليد منه، بناءً على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره، وتعظيمهم له بخلاف الغير.. فإن كان هناك منتصبون، فترَكَهم هذا المقلد، وقلَّد غيرهم، فهو آثم". ويعلل الشَّاطبي ذلك، فيقول: "إذ لم يرجع إلى مَن أُمِر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين، فهو غير معذور؛ إذ قلد في دِينه مَن ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر، فعمل بالبدعة، وهو يظن أنه على الصراط المستقيم"[11]. وعلى هذا، فالسبب في تأثيمه هو كونه مقصرًا فيما وجب عليه؛ إذ إن الواجب على المقلد أن يجتهد فيمن يستفتيه ويقلده، هل هو متصفٌ بوصف العلم أو لا؟ ولما أن كان الشَّاطبي يرى أن البدعة المستمرة لا يمكن أن تصدر من عالم راسخ، وإنما تصدر من متعالم أحسَنَ الظنَّ بنفسه، فادعى الاجتهاد، وليس أهلًا له، فاتباع العامي للمبتدع هو في حقيقته اتباع من ليس أهلًا للاتباع، والعامي لا يجوز له اتباع غير العالم، ولو اتبعه لم يُعذَرْ بذلك، لا سيما في مثل هذه الحالة، وهي ما إذا كان الأهل منتصبًا للاقتداء. ولذا؛ فلا يعترض على رأيه هنا بأن الشَّاطبي يرى التخيير بين العلماء، فللمستفتي سؤال أيهما شاء[12]؛ لأن رأيه في التخيير مشروط بصدق وصف العلم عليهم، وليس الأمر في المبتدع كذلك، وهذه الحالة - كما ذكر الشَّاطبي - هي كحال مَن بُعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم تركوا الحق، وتمسكوا بما عليه الآباء من الباطل، ولم ينظروا نظر المستبصر، أو يفرقوا بين الطريقين، فغطى الهوى على عقولهم؛ ولذلك قلما تجد مَن هذا وصفه إلا وهو يوالي ويعادي مِن أجل مَن يقلده، ولا حجة له إلا التقليد المحض. وقد جاء عن أبي الطفيل الكناني أن رجلًا وُلد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة، وأخذ بجبهته، فنبتت شعرة بجبهته كأنها سُلْفة فرس[13]، قال: (فشب الغلام، فلما كان زمن الخوارج أجابهم، فسقطت الشعرة من جبهته، فأخذه أبوه فقيَّده وحبسه؛ مخافةَ أن يلحق بهم)، قال: (فدخلنا عليه فوعظناه، وقلنا له: ألم ترَ بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت؟!)، قال: (فلم نزَلْ به حتى رجع عن رأيهم؛ فردَّ الله - عز وجل - الشعرة في جبهته؛ إذ تاب)[14]. وأما إن لم يكن ثَمَّ منتصبون إلا هذا المبتدع الخامل بين الناس، وهو قد انتصب لِما ليس هو له بأهل، وقلده هذا العامي، فهل يأثم أو لا؟! قال الشَّاطبي: "ففي تأثُّمِه نظر، ويتحمل أن يقال فيه: إنه آثم"[15]، والشَّاطبي يرى أن مَن هذا حاله فحكمه كحكم أهل الفترة[16]؛ ولذا قال: "ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعًا لآبائهم، واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله، وما أشبه ذلك"[17]. وقد حَكَى الشَّاطبي قولي العلماء في حكم أصحاب الفترة، وكيف يستخلص من ذلك حكم المسألة التي يبحث فيها: فعلى القول بالتفصيل في حكم أصحاب الفترة، وأنهم على قسمين: قسم غابت عنه الشريعة وخفيت عليه، فلم يدرِ ما يتقرب به إلى الله، فتوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه قربة، ورأى ما عليه أهل عصره من اتباع ما تستحسنه عقولهم، فوقف دونه، وكف عنه، فهذا وأمثاله مندرج تحت قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15]. والقسم الثاني: خالَط ما عليه أهل عصره من الشرك والتحليل والتحريم بحسب الرأي والهوى واستحسان العقل، فوافقهم في ذلك كله، فليس هو بالمعذور، بل هو آثم كأهل عصره؛ لأنه وافقهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشريعة؛ فصار من أهلها، فكذلك العامي في هذه المسألة، إن خفِيَ عليه الحق، ولم يدرِ ما يتقرب به إلى الله، فكفَّ عن متابعة العقل والبدعة، هذا غير آثم، وإن خالط البدعة وأهلها، فهو آثم. وفيما ذكر الشَّاطبي نظر؛ لأن القسم الأول على هذا القول هو من غابت عنه الشريعة، فكف عن العمل، ومثاله في مسألتنا العامي الذي غاب عنه الحق، فكف عن متابعته، وعن متابعة البدعة، والفرض ليس كذلك؛ إذ الفرض أن العامي قد قلَّد المقلِّد المبتدع على بدعته؛ ولذا فالفرق بين هذا القسم وما ألحق به واضحٌ في نظري. أما القول الثاني في حكم أهل الفترة: فقد ذكره بقوله: "ومن العلماء من يطلق العبارة، ويقول: كيفما كان لا يُعذَّب أحدٌ إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم، وهذا إن ثبت قولًا هكذا، فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة، فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول، فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء، ورجاء السلامة[18]، وإن اقتصر على الأول ظهر عنادُه؛ لأنه مع هذا الفرض لم يرضَ بهذا الطارئ، وإذا لم يرضَه كان ذلك لهوى داخله، وتعصب جرى في قلبه مجرى الكَلَب[19] في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعُدْ أن ينتصر لمذهب صاحبه، ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته، وحكمه قد تقدم في القسم قبله"[20]، ويلاحظ أن الشَّاطبي قد حكى القولين، ولم يُشِرْ إلى ترجيح أي منهما[21]. وقد وافق الشَّاطبيَّ على ما ذكر مِن تأثيم أصحاب القسم الأول، ومَن كان قادرًا على معرفة الحق، وأن من كان عاجزًا فحكمه كحكم أهل الفترة - على الخلاف في حكم أهل الفترة - ابنُ تيمية[22] وابن القيم[23]، وغيرهما[24]، كما أنه هو ظاهر كلام ابن حزم[25]. قال ابن القيم: "طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحَمِيرهم الذين هم معهم تبعًا لهم، يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على أسوة بهم... وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفَّار، وإن كانوا جهالًا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة، ولا التابعون، ولا من بعدهم..."[26]. وقال: "نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق، فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود؛ فالمتمكن المعرض مفِّرط، تارك للواجب عليه، لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، فهو قسمان..."، ثم ذكر أن الأول: من أراد الحق، ولم يحصله، فحكمه كحكم أهل الفترة، والثاني: من رضي بما هو عليه، ولم يطلب الحق، ولم يبين ابن القيم حكم هذا القسم، غير أن من لازم كلامه السابق - وما يُشعِر به كلامه فيه - أنه مؤاخذ بذلك، ولا يُعذَر بجهله[27]. أدلة الشَّاطبي ومن وافقه: استدل الشَّاطبي على ما ذهب إليه مِن أن العامي المستدل للبدعة، أو المتبع للمبتدع مع انتصاب مَن هو أولى منه آثمٌ - بدليلين: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى أصحاب بدع وأهواء، وقد استدلوا عليه بما ذهب إليه آباؤهم وعظماؤهم، وردوا الحق الذي جاء به، واستولى على قلوبهم الهوى، حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها، وذلك كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [المائدة: 104]، ومع ذلك كان مَن مات منهم على الكفر، سِيق إلى النار، مِن غير تفريق بين المعاند وغيره، وما ذاك إلا لقيام الحجة عليهم بمجرد بعثته وإرساله لهم صلى الله عليه وسلم، مبينًا لهم الحق الذي رفضوه، فكذلك العامي، إذا كان متبعًا لمقلد خامل قد انتصب مَن هو أولى وأعلم منه ففرَّط ولم يتبعه، فإنه مفرِّط مؤاخَذ لتقصيره كالمشركين، ولا فرق بين مَن استدل أو غيره ممن لم يستدل، وكان تبعًا لِمَن استدل، كما هو حال المشركين في عهد النبوة[28]. الدليل الثاني: أن لفظة أهل الأهواء وأهل البدع إنما تُطلَق على مَن ابتدع البدعة واستنبطها، أو ناصَرها، أو استدل لها حتى غَدَتْ بدعتُهم منظورًا فيها، ومحتاجًا إلى الرد عليها، كما هو حال أهل الفرق من المعتزلة والخوارج وغيرهم؛ ويرشح هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ﴾ [الأنعام: 159]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾ [آل عمران: 105]، وقوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 7]. فإن الآية الأولى مُشعِرة بإطلاق التفرق على من جعل الفعل الذي هو التفرق، وهو في الحقيقة مَن اخترع البدعة أو قام مقامه، ومثلها الثانية، وأما الثالثة فإنها مشعِرة بأن من يفعل ذلك إنما هو من نصب نفسه منصب المجتهد وليس أهلًا، ويرشحه قوله صلى الله عليه وسلم: ((حتى إذا لم يبقَ عالمٌ، اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا، فأفتَوْا بغير علم))[29]؛ لأنهم أقاموا أنفسهم ونصبوها مناصب المجتهدين، وهذا بخلاف العوام؛ فإنهم متَّبِعون لعلمائهم؛ إذ هذا فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه ولا للهوى حقيقة؛ ولذا لا يطلق عليهم أنهم من أهل الأهواء، وليس من يطلق عليه لفظ الابتداع كغيره في الحكم بلا ريب[30]. [1] انظر: الاعتصام (2/ 403، 466). [2] الاعتصام (1/ 115). [3] الاعتصام (1/ 115). [4] القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة، ويسمون بالقرامطة نسبة إلى حمدان بن قرمط، وقيل لغير ذلك، ويسمون بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق، ويسمون بالباطنية؛ لأنهم ادعوا أن لظواهر النصوص بواطن لا يعلمها إلا هم، ويسمون بالتعليمية؛ لأنهم أبطلوا الرأي والعقل، ودعَوُا الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم، وأنه لا مدرك للعقول إلا بالتعليم منه، وقد كانت نشأة مذهبهم سنة 278هـ، ومن آرائهم: أن الإمامة في محمد بن إسماعيل بعد أبيه، وأنه حي لم يمت، ولا يموت حتى يملِكَ الأرض، وأنه هو المهدي، وأن العالم قديم، وأنكروا القيامة والحشر، وادعوا أن من أحاط بالحقائق ارتفعت عنه قيود العبودية، والخلاصة أن مذهبهم ظاهره الرفض، وباطنه الكفر المحض؛ انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 100) الفرق بين الفرق (42، 213) الملل والنحل (1/ 167) المنتظم (12/ 287) وفيات الأعيان (2/ 147). [5] انظر لهذه القصة: المنتظم (12/ 291 - 292). [6] الأقانيم: جمع واحدها الأقنوم: ويعني الجوهر والشخص والأصل، ويستعمل عند النصارى، ويعنون به الثالوث الأقدس: الأب، والابن، والروح القدس، وهو عندهم إله واحد، ومنهم من يرى أن الإلهة أقنوم واحد، إلا أنه اسم لثلاثة معانٍ: الأب والابن والجوهر، وهو عند هؤلاء الروح القدس؛ انظر: الملل والنحل (1/ 226) الحور العين (146) إظهار الحق (1/ 576) محاضرات في النصرانية (121) المعجم الوسيط (22) مادة: "أقن". [7] الجوهر: جوهر الشيء: حقيقته وذاته، ومعناه عند المتكلمين والفلاسفة: الموجود القائم بنفسه، وعرف أيضًا: بأنه ماهية إذا وجدت في الأذهان كانت لا موضوع لها، والنصارى يقولون: إن المسيح إنسان بجوهر الناسوت - يعني الناس - وإله بجوهر اللاهوت، واختلفوا في كيفية اجتماع الجوهرين، ونتيجة ذلك الاجتماع؛ انظر: الفصل في الملل والنحل (1/ 65) هداية الحيارى (304 - 306) إظهار الحق (1/ 576) وانظر لتعريف الجوهر: المعجم الوسيط (149) مادة: "جوهر"، معيار العلم (291) التعريفات (108) كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 275). [8] انظر: الاعتصام (1/ 115 - 116). [9] انظر: الاعتصام (1/ 115). [10] الاعتصام (1/ 120). [11] الاعتصام (1/ 116 - 117). [12] انظر: (ص 818) من هذا البحث. [13] سُلْفة الفرس: سلفة بضم السين وسكون اللام، ويقال لها السالفة: وهي أعلى العنق، وهي من الفرس ما تقدم من عنقه؛ انظر: لسان العرب (6/ 332) القاموس المحيط (1061) المعجم الوسيط (444) كلها مادة: "سلف". [14] رواه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجمل، ما ذكر في الخوارج (7/ 556/ 37904) وأحمد في المسند (5/ 456)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 246): "رواه أحمد، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وقد وُثِّق، وبقية رجاله رجال الصحيح". [15] الاعتصام (1/ 117). [16] أهل الفترة: هم الذين كانوا في حين انقطاع من الرسل، ويلحق بهم من كان حين فتور آثار الرسالة وميراث النبوة وغياب العلماء الصادقين، وقد اختُلف في حكمهم؛ فقيل: هم في النار، وقيل بالتوقف في شأنهم، وقيل: يُعذَرون في الدنيا، ويمتحنون في الآخرة، واختاره أبو الحسن الأشعري، ونصره البيهقي، كما قال ابن كثير، واختاره هو أيضًا، وقال ابن حجر: "وقد صحَّتْ مسألة الامتحان في حق المجنون، ومَن مات في الفترة من طرق صحيحة"؛ انظر: مجموع الفتاوى (35/ 164 - 165) تفسير القرآن العظيم (3/ 31) فتح الباري (3/ 246) أضواء البيان (3/ 481). [17] الاعتصام (1/ 117) وفيه استنامة، والصواب استقامة، كذا فيه بتحقيق/ الهلالي (1/ 210). [18] كذا في الطبعتين، ولعل الصواب ورجى، فيكون فعلًا ماضيًا معطوفًا على قوله: أخذ. [19] الكَلَب: بفتحتين أصله كلب الكلب كلبًا من باب تعب: وهو داء يشبه الجنون، يأخذ الكَلْب، فيعقر الناس، ويقال لمن عضه الكَلْب: به داء الكَلَب: وهو مرض مُعْدٍ، يعرف برهبة الماء، ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى الإنسان وغيره، ومن ظواهره تقلصات في عضلات التنفس والبلع، وخيفة الماء، وجنون، واضطرابات أخرى شديدة في الجهاز العصبي؛ انظر: لسان العرب (12/ 135) المصباح المنير (2/ 537) القاموس المحيط (169) المعجم الوسيط (794) كلها مادة: "كلب". [20] الاعتصام (1/ 118). [21] انظر: الاعتصام (1/ 118، 120). [22] انظر: مجموع الفتاوى (22/ 16، 36/ 164 - 165) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 583) بغية المرتاد (311). [23] انظر: طريق الهجرتين (675 وما بعدها)، النونية مع شرحها توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (2/ 404). [24] كالشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد (490) وابن عيسى في شرحه للنونية المسمى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (2/ 404 - 405) وانظر للمسألة: حقيقة البدعة وأحكامها (2/ 225 وما بعدها). [25] انظر: الفصل في الملل والنحل (2/ 277). [26] طريق الهجرتين (675). [27] انظر: طريق الهجرتين (678). [28] انظر: الاعتصام (1/ 117 - 118). [29] سبق تخريجه (ص 279). [30] انظر: الاعتصام (1/ 118 - 119). hgjrgd] td hgf]Qu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح  واصل ولا تحرمنـا من جديـدك المميـز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
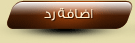 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
 |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
| |
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018