 أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا  الإهداءات الإهداءات | |
| الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
 « آخـــر الــمــواضــيــع » « آخـــر الــمــواضــيــع » |
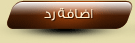 |
| كاتب الموضوع | صقر الاسلام | مشاركات | 6 | المشاهدات | 4018 |  | |  | |  | انشر الموضوع |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح مقدمــة: - تعريف المحاسن: قال الجوهري: "الحُسْن: نقيض القبح، والجمع محاسن على غير قياس، كأنه جمع مَحْسَن"[1]. وقال ابن سيده: "وليس بالقوي، قال سيبويه: هو جمع لا واحد له، ولذلك إذا أضاف إليه قال محاسني". قال: "والمحاسن في الأفعال: ضد المساوئ"[2]. - الضروريات الخمس: قال الشاطبي: "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين... ومجموع الضروريات خمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل"[3]. وقال الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ورفعها مصلحة. وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح"[4]. 1- الأدلة على مراعاة الضروريات الخمس: أ- من الكتاب: قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوٰلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ مّنْ إمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لاَ نُكَلّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ}[الأنعام:151، 152]. ففي هذه الآيات تظهر العناية بحفظ هذه الضرورات ظهورا جليا واضحا. فقد جاء في حفظ الدين نهيه سبحانه عن الشرك به، وجاء في حفظ النفس قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ مّنْ إمْلَـٰقٍ} [الأنعام:151]، وقوله تعالى:{وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الأنعام:151]، وجاء حفظ النسل في قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام:151]، ومن أعظم الفواحش الزنا الذي وصفه الله بأنه فاحشة في قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء:32]، وجاء حفظ المال في قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ}، وقوله: {وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ}، وأما حفظ العقل فإنه يؤخذ من مجموع التكليف بحفظ الضرورات الأخرى؛ لأن الذي يفسد عقله لا يمكن أن يقوم بحفظ تلك الضرورات كما أمر الله، ولعل في ختام الآية الأولى: {ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام:151] ما يدل على ذلك[5]. وقال تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِٱلْوٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا * رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَـٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ غَفُوراً * وَءاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبّهِ كَفُورًا * وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاء رَحْمَةٍ مّن رَّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا * وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً * وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَـٰناً فَلاَ يُسْرِف فّى ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً * وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً * وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلأرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً * كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيّئُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء:23- 38]. جاء ما يدل على حفظ الدين في مطلعها في قوله: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّـٰهُ}. وجاء حفظ المال في قوله: {وَءاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ} وقوله: {وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرًا}. وجاء حفظ النفس في قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ} وقوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقّ}[6]. ب- من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))[7]. قال عبد الله قادري: "وقد سمى صلى الله عليه وسلم الاعتداء على هذه الأمور موبقاً أي مهلكاً، ولا يكون مهلكاً إلا إذا كان حفظ الأمر المعتدى عليه ضرورة من ضرورات الحياة"[8]. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك[9]. قال عبد الله قادري: "فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ هذه الضرورات، وهي حفظ الدين في قوله: {أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} وحفظ النفس في قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقّ} وحفظ النسل والنسب والعرض في قوله: {وَلاَ يَزْنِينَ} وقوله: {وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} وحفظ المال في قوله: {وَلاَ يَسْرِقْنَ}"[10]. ج- استقراء أدلة الشرع: قال الشاطبي: "فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد"[11]. 2- ترتيب الضروريات: قال ابن أمير الحاج: "ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة لأنه المقصود الأعظم، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]، وغيره مقصود من أجله، ولأن ثمرته أكمل الثمرات وهي نيل السعادة الأبدية في جوار ربّ العالمين، ثم يقدم حفظ النفس على حفظ النسب والعقل والمال لتضمنه المصالح الدينية لأنها إنما تحصل بالعبادات، وحصولها موقوف على بقاء النفس، ثم يقدم حفظ النسب لأنه لبقاء نفس الولد إذ بتحريم الزنا لا يحصل اختلاط النسب، فينسب إلى شخص واحد فيهتم بتربيته وحفظ نفسه، وإلا أهمل فتفوت نفسه لعدم قدرته على حفظها، ثم يقدم حفظ العقل على حفظ المال لفوات النفس بفواته حتى إن الإنسان بفواته يلتحق بالحيوانات ويسقط عنه التكليف، ومن ثمة وجب بتفويته ما وجب بتفويت النفس وهي الدية الكاملة، ثم حفظ المال"[12]. 3- طرق المحافظة على الضروريات: قال الشاطبي: "والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات. والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم"[13]. [1] الصحاح (5/2099). [2] المخصص (2/151). [3] الموافقات (2/17-18). [4] المستصفى (2/482). [5] الإسلام وضرورات الحياة (ص 16- 17). [6] الإسلام وضرورات الحياة (ص18- 19). [7] أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} (2615)، ومسلم في الإيمان (89). [8] الإسلام وضرورات الحياة (ص20). [9] أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار (17)، ومسلم في الحدود (1709). [10] الإسلام وضرورات الحياة (ص 21). [11] الموافقات (1/31). [12] التقرير والتحبير (3/231). 13 الموافقات (2/18- 20). lphsk hgYsghl lk oghg pt/i ggqv,vdhj hgols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1ـ العمل بالدين: أوجب الله تعالى حداً أدنى يحفَظ به هذا الدين على كل فرد من أفراد المسلمين، وهو فرض العين الذي لا يسقط عن أحد ما دام قادراً على إقامته قدرة عقلية وقدرة فعلية وذلك مثل أصول الإسلام والإيمان[1]. قال شيخ الإسلام: "والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً، الذي يجب لله عبادةً محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً له الدين وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب المصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس"[2]. وهناك حد أدنى من المحرمات حظرها الله تعالى على كل فرد فهي محرمات عينية مطلوب من كل فرد اجتنابها، وهي المحرمات التي حظرت لذاتها لما يلحق الفرد والمجتمع من الضرر بسبب ارتكابها كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغيرها، فإنه يحرم على كل فرد من الأمة أي محرم منها إلا ما اضطر إليه مما لا حياة له بدونه مما يمكن تناوله كأكل الميتة، وقد رتب الله تعالى على امتثال أمره واجتناب نهيه السعادة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، كما رتب على عصيانه الشقاء في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وتعالى: {وَٱلْعَصْرِ *إِنَّ ٱلإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ *إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ} [العصر:1-3]. قال ابن كثير: "فاستثنى من جنس الإيمان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم {وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقّ} وهو أداء الطاعات وترك المحرمات"[3]. 2ـ الحكم بالدين: قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ} [النساء:105]. قال ابن السعدي: "الحكم هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام"[4]. وقال تعالى: {فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزلَ ٱللَّهُ}. قال ابن كثير: "أي: فاحكم ـ يا محمد ـ بين الناس، عربهم وعجمهم أميِّهم وكتابيهم، بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم"[5]. قال الشيخ عبد الله قادري: "إن المراد بحفظ هذا الدين أن يؤدي غرضه في الأرض، أن يحكم تصرفات البشر، أن يقضي لصاحب الحق بحقه ويرد على صاحب الباطل باطله. إن الناس يعتدي بعضهم على بعض في هذه الضرورات التي لا حياة لهم بدونها، ويعتدون على دينهم وعلى نسلهم وعرضهم ونسبهم وعقلهم ومالهم ونفوسهم، وليس هناك مبدأ من المبادئ الموجودة في الأرض قادر على حفظ هذه الضرورات حفظاً يكفل لهم الحياة السعيدة إلا هذا الدين، فالحكم بما أنزل الله ضرورة من ضروريات حفظ الدين"[6]. 3ـ الدعوة إلى الدين: قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ} [فصلت:33]. قال ابن جرير: "أي: ومن أحسن ـ أيها الناس ـ قولاً ممن قال: ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه، ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك؟!"[7]. وقال تعالى: {وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} [آل عمران:104]. قال ابن كثير: "يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون"[8]. قال شيخ الإسلام: "إن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ} [آل عمران:110]، وقال تعالى: {وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ}، وقال تعالى: {وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ} [التوبة:71]، وقال تعالى عن بني إسرائيل: {كَانُواْ لاَ يَتَنَـٰهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} [المائدة:79]، وقال تعالى: {فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوء وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ} [الأعراف:165]. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجي الذين ينهون عن السوء، وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد"[9]. 4ـ الجهاد في سبيل الله: قال تعالى: {وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ} [الأنفال:39]. قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني: حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان"[10]. وقال تعالى: {وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدّمَتْ صَوٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيراًً} [الحج:40]. قال ابن سعدي: "وهذا يدل على حكمة الجهاد؛ فإن المقصود منه إقامة دين الله أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة"[11]. وقال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزْلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ} [الحديد:25]. قال ابن كثير: "أي: وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه"[12]. قال شيخ الإسلام: "ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدي به وحديد ينصره، فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين"[13]. 5ـ رد البدع والأهواء: عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه سلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[14]. قال النووي: "وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات"[15]. وظهور البدع له مضار على الدين نفسه، مثل خفاء كثير من أحكامه وتشويه جماله، والأول سبب من أسباب اندراس الشرائع، والثاني سبب من أسباب الإعراض عنها وعدم احترامها، ويتجلى هذا في بدع أهل الطرق وغيرها، مما يصوِّر الدين تصويراً يأباه ما للدين من جمال وجلال، وكثيراً ما تنشر البدع وتأخذ مكانة الدين من النفوس، وتصير هي الدين المتبع عند الناس، وبقدر ذيوعها يكون اندراس الدين، وهذا هو الطريق الذي اندرست به الشرائع السابقة وانحرف عنها المتدينون[16]. 6ـ إقامة حد الردة: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[17]. قال شيخ الإسلام: "وأما المرتد فالمبيح عنده (يعني عند أحمد) هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع خاص من الكفر، فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه"[18]. [2] مجموع الفتاوى (7/314). [3] تفسير القرآن العظيم (4/585) وانظر: الإسلام وضرورات الحياة (ص 32). [4] تيسير الكريم الرحمن (ص 199). [5] تفسير القرآن العظيم (2/105). [6] الإسلام وضرورات الحياة (ص 40) بتصرف يسير. [7] جامع البيان (11/109). [8] تفسير القرآن العظيم (1/398). [9] مجموع الفتاوى (28/306- 307). [10] جامع البيان (2/200). [11] تيسير الكريم الرحمن (ص 489). [12] تفسير القرآن العظيم (4/315). [13] مجموع الفتاوى (35/36). [14] أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح جور (2697)، ومسلم في الأقضية (1718). [15] شرح صحيح مسلم (12/16). [16] البدعة: أسبابها ومضار (ص 57) محمود شلتوت، بواسطة علم أصول البدع ص 287 لعلي حسن عبد الحميد. [17] أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمحاربين، باب قتل المرتد والمرتدة (6922). [18] مجموع الفتاوى (20/102). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1ـ تحريم الاعتداء على النفس: قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:92]. قال ابن كثير: "وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيت يقول سبحانه في سورة الفرقان: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الفرقان:68]، وقال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} إلى قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الأنعام:151]. والآيات والآحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً"[1]. قال ابن حزم: "لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين: أحدهما: ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها. والثاني: قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير حق"[2]. 2ـ سد الذرائع المؤدية للقتل: لقد حرصت الشريعة الإسلامية على سد الذرائع المفضية إلى *** المفاسد وتفويت المصالح، فحرمت الاعتداء على المسلمين وحمل السلاح عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))[3]. قال ابن دقيق العيد: "فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه"[4]. وقال صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر))[5]. قال الحافظ ابن حجر: "لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبَّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق والكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير"[6]. وكذلك قرر الفقهاء الضمان بالتسبب إلى قتل النفس. قال ابن قدامة: "ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، فإذا حفر بئراً في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع حجراً أو حديدة أو صب فيه ماء أو وضع فيه قشر بطيخ أو نحوه فهلك به إنسان أو دابة ضمنه"[7]. 3ـ القصاص في القتل: قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} [البقرة:178]. قال ابن عطية: "وصورة فرض القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه وترك التعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله، وأن الحكام فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وليس القصاص بلزام إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من ديَّة أو عفو فذاك مباح، فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح"[8]. وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يأُولِي ٱلألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179]. قال قتادة: "جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همَّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه"[9]. 4ـ العفو عن القصاص: قال تعالى: {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء فَٱتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ} [البقرة:178]. قال ابن سعدي: "فيه ترقيق وحث على العفو إلى الديَة، وأحسن من ذلك العفو مجاناً"[10]. قال سيد قطب: "ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل في التوراة إنما شرع للأمة الإسلامية استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء"[11]. وقال سيد أيضاً: "ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع، إن الغضب للدم فطرة وطبيعة، فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص، فالعدل الجازم هو الذي يكسر شره النفوس ويفتأ حنق الصدور ويردع الجاني كذلك عن التمادي، ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو ويفتح له الطريق ويرسم له الحدود، فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع، لا فرضاً يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق"[12]. 5ـ تحريم الانتحار: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومعه تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يديه يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً))[13]. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم))[14]. قال النووي: "في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتل نفسه"[15]. إن الإنسان ملك لخالقه وليس ملكاً لنفسه؛ لذلك لا يجوز أن يتصرف في نفسه إلا في حدود ما أذن له الخالق، فليس له أن يضر نفسه بحجة أنه لم يتعد على أحد، لأن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غيره عند الله تعالى[16]. 6ـ إباحة المحظورات للضرورة: قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النحل:115]. وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]. قال ابن جرير: "فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله"[17]. قال ابن كثير: "قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم"[18]. قال ابن حزم: "وكل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع، طائر أو ذي أربع، أو حشرة أو خمر أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال، حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل من ذلك شيء لا بضرورة ولا بغيرها، فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا قبل ولم يجد مال مسلم أو ذمي فله أن يأكل حتى يشبع، ويتزود حتى يجد حلالاً، فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراماً كما كان عند ارتفاع الضرورة"[19]. وتظهر محافظة هذا العنصر على النفس من وجهين: الأول: جواز المحرمات للضرورة، وقد تقدم ذكره. والثاني: وجوب بذل المال للمضطر إنقاذاً لنفسه من الهلاك. قال النووي: "إذا لم يكن المالك مضطراً فيلزمه إطعام المضطر مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً، وللمضطر أن يأخذه قهراً وله مقاتلة المالك عليه، فإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه، وإن قتل المالكُ المضطرَّ في الدفع عن طعام لزمه القصاص"[20]. [2] المحلى (10/342). [3] أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح (707). [4] انظر: فتح الباري (13/27). [5] أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر (48)، ومسلم، كتاب الإيمان (116). [6] فتح الباري (1/138). [7] المغني (12/88). [8] المحرر الوجيز (1/244). [9] جامع البيان (2/119). [10] تيسير الكريم الرحمن (ص67). [11] في ظلال القرآن (1/164- 165). [12] في ظلال القرآن (1/164- 165). [13] أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به (5778)، ومسلم في الإيمان (109). [14] أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس (1363)، ومسلم في الإيمان (110). [15] شرح صحيح مسلم (2/125). [16] الإسلام وضرورات الحياة (ص 54). [17] جامع البيان (2/91). [18] تفسير القرآن العظيم (2/174). [19] المحلى (7/426). [20] المجموع (9/48). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1ـ جعل العقل مناط التكليف: قال الآمدي: "اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة، ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً ونهياً ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن كون الآمر به هو الله تعالى وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه أيضاً"[1]. وإذا كان العقل هو مناط التكليف في الشريعة الإسلامية فإن حفظه إذاً ضرورة لا غنى عنها ولا تستقيم حياة الناس بدون ذلك[2]. 2ـ تحريم ما يفسد العقل: مما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بحفظ العقل أنها حرمت كل ما من شأنه إفساد العقل وإدخال الخلل عليه، وهذه المفسدات على قسمين: أ- مفسدات حسية: وهي التي تؤدي إلى الإخلال بالعقل بحيث يصبح الإنسان كالمجنون الذي لا يعرف صديقاً من عدو ولا خيراً من شر، فيختل كلامه المنظوم، ويذيع سره المكتوم، وهذه المفسدات هي الخمور والمخدرات وما شابهها[3]. قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأنصَابُ وَٱلأزْلاَمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاء فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة:90، 91]. قال سيد قطب: "إن غيبوبة السكر بأي مسكر تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً بالله في كل لحظة مراقباً لله في كل خطوة، ثم ليكون بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددها، وفي صيانتها من الضعف والفساد، وفي حماية نفسه وماله وعرضه وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء، والفرد المسلم ليس متروكا لِذاته ولَذَّاته، فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة، تكاليف لربه وتكاليف لنفسه وتكاليف لأهله وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيها وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها، وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف، وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظاً لهذا المتاع فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة، إنما يسيطر دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره، وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه. ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار، والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق، ويريد من الناس أن يروا الحقائق وأن يواجهوها ويعيشوا فيها ويصرفوا حياتهم وفقها ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام... إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة والإرادة، أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل ووهن العزيمة وتذاوب الإرادة، والإسلام يجعل في حسابه دائماً تربية الإرادة، وإطلاقها من قيود العادة القاهرة والإدمان، وهذا الاعتبار كاف وحده من عمل الشيطان مفسد لحياة الإنسان"[4]. فالخمر من أعظم أسباب التعدي على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها، فكم حصل بسببها من سفك للدماء المحرمة وانتهاك للأعراض وإتلاف للأموال وإفساد للعقول وتفويت لمصالح الدين، ومنشأ ذلك هو اختلال العقل المدرك القائد للإنسان إلى مصالحه[5]. ب- مفسدات معنوية: وهي ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة في الدين أو الاجتماع أو السياسة أو غيرها من أنشطة الحياة، فهذه مفسدة للعقول من حيث كون الإنسان قد عطل عقله عن التفكير السليم الذي يوافق الشرع، فعقله من هذه الحيثية كأنه فاسد لا يفكر، بل كأنه معدوم بالمرة. لذا نعى الله في كتابه على الكفار حيث عطلوا عقولهم عن التفكير في آيات الله القرآنية وآياته الكونية، فلم يستفيدوا منها في الوصول إلى الحق، قال تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلأنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} [الفرقان:44]. قال ابن سعدي: "سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنعام"[6]. فالعقل إن لم يجعل مطية للوصول إلى فهم كلام الله وكلام رسوله والتدبر في خلق الله وبديع صنعته فإن وجوده كعدمه، فيجب تسخير العقل في الوصول إلى الحق والمحافظة عليه من كل دخيل أو مذهب هدام أو نحلة باطلة تغير مفهوماته الشرعية[7]. 3- عقوبة شرب المسكر: قال الإمام البخاري في صحيحه: "باب ما جاء في ضرب شارب الخمر"، ثم أخرج بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين[8]. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا أو فسقوا جلد ثمانين[9]. قال ابن قدامة: "يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ"[10]. وقال ابن حزم: "واتفقوا أن من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمراً من عصير العنب وقد بلغ ذلك حدَّ الإسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر به ساعةَ شربها ولم يكن في دار الحرب أن الضرب يجب عليه إذا كان حين شربه لذلك عاقلاً مسلماً بالغاً غيرَ مكرَه ولا سكران، سكِر أو لم يسكر"[11]. وقال ابن حزم أيضاً: "واتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين، واختلفوا في إتمام الثمانين، واتفقوا أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين"[12]. [2] الإسلام وضرورات الحياة (ص 112). [3] مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص237). [4] في ظلال القرآن (2/977). [5] مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 223، 229) بتصرف. [6] تيسر الكريم الرحمن (ص 584). [7] مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 243- 244). [8] صحيح البخاري: كتاب الحدود (6773)، وأخرجه مسلم أيضا في الحدود (1706). [9] أخرجه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (6779). [10] المغني (12/497). [11] مراتب الإجماع (ص133). [12] مراتب الإجماع (ص133). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1ـ الترغيب في تكثير النسل: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: ((لا))، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم))[1]. قال الطيبي: "وفيه فضيلة كثرة الأولاد لأن بها يحصل ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من المباهاة"[2]. قال المناوي: "لا ينتظم أمر المعاش حتى يبقى بدنه سالما ونسله دائما، ولا يتم كلاهما إلا بأسباب الحفظ لوجودهما وذلك ببقاء النسل، وقد خلق الغذاء سببا للحيوان، وخلق الإناث محلا للحراثة، لكن لا يختص المأكول و المنكوح ببعض الآكلين والناكحين بحكم الفطرة، ولو ترك الأمر فيها سدى من غير تعريف قانون الاختصاصات لتهاوشوا وتقاتلوا وشغلهم ذلك عن سلوك الطريق، بل أفضى بهم إلى الهلاك فشرح الله قانون الاختصاص بالأموال في آيات نحو المبايعات والمداينات والمواريث ومواجب النفقات والمنكاحات ونحو ذلك، وبين الاختصاص بالإناث في آيات النكاح ونحوها"[3]. 2ـ الترغيب في النكاح: قال الإمام البخاري: "باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء} [النساء:3]"[4]. قال الحافظ: "ووجه الاستدلال بالآية أنها صيغة أمر تقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب"[5]. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))[6]. قال النووي: "وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه"[7]. قال الغزالي في بيان فوئد النكاح: "الفائدة الأولى وهو الأصل وله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس"[8]. 3ـ التحذير من التبتل والرغبة عن النكاح: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا[9]. قال الحافظ: "والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية"[10]. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أماَ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))[11]. قال الحافظ: "وقوله: ((فليس مني)) إن كانت الرغبة بضرب من التآويل يعذر صاحبه فيه فمعنى ((فليس مني)) أي: على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى ((فليس مني)) ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر، وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه"[12]. هذا بالنسبة لمن ترك النكاح تبتلا وانشغالاً بالعبادة، فأما من تركه لعدم القدرة البدنية أو المالية فبين العلماء حكمه كما يلي. قال ابن قدامه: "القسم الثالث: من لا شهوة له؛ إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان: أحدهما: يستحب له النكاح. والثاني: التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضر بها ويحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه، والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليها"[13]. 4ـ تحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل: قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ مّنْ إمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}. وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء:31]. قال القاسمي: "{إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} لإفضائه إلى تخريب العالم، وأي خطأ أكبر من ذلك"[14]. وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ} الآية [الممتحنة:12]. قال ابن كثير: "قوله: {وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ} هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتلَه وهو جنين كما يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه"[15]. وقد أوجب الشرع الضمان على من قتل جنيناً في بطن أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبدٍ أو أمة[16]. وعن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص[17] المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، قال: ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به[18]. قال ابن تيمية في الجواب عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: "يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غُرة: عبد أو أمة، تكون لورثة الجنين غير أمه"[19]. وينبه هنا إلى أن إسقاط الحمل على نوعين كما يأتي. قال الشيخ محمد بن عثيمين: "أما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب؛ لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ومنم من قال: يجوز ما لم يكن علقة، أي: ما لم يمض عليه أربعون يوماً، ومنهم من قال: يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان، والأحوط المنع من إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع. الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه، بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ولا يحتاج الأمر إلى عملية"[20]. والإجهاض له آثار على النسل، فمن ذلك: 1) هلاك عدد غير معلوم من أفراد البشرية قبل أن يخرجوا إلى نور الحياة. 2) ذهاب عدد غير يسير من الأمهات ضحية الموت أثناء عملية الإجهاض. 3) حدوث مؤثرات مرضية للمرأة لا يستهان بعددها تؤدي عدم الإنجاب مستقبلاً[21]. 5ـ الوعيد الشديد على نفي النسب أو إثباته على خلاف الواقع: قال تعالى: {ٱدْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءابَاءهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِى ٱلدّينِ وَمَوٰلِيكُمْ} [الأحزاب:5]. قال ابن كثير: "أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي: عوضاً عما فاتهم من النسب"[22]. وقال الشوكاني: "صرح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء"[23]. وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار))[24]. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل))[25]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر))[26]. وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام))[27]. قال الحافظ: "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره"[28]. قال بعض الشراح: "سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله، كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان، وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره"[29]. 6ـ تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه: قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء:32]. قال ابن جرير: "وساء طريق الزنا طريقاً، لأنه طريق أهل معصية الله والمخالفين أمره، فأسوِئ به طريقاً يورد صاحبه نار جهنم"[30]. قال ابن سعدي: "ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة أي: إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد"[31]. وقد أوجبت الشريعة الحد في هذه الجريمة. قال تعالى: {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))[32]. قال شيخ الإسلام: "وأما الزاني فإن كان محصناً فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ورجم الغامدية وغير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله، ويغرب عاماً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"[33]. ومن مقاصد الشريعة في تحريم الزنا: 1) تحقيق العبودية لله تعالى والاستقامة على شرعه. 2) تطهير المكلف من الذنوب والآثام وردع غيره من الوقوع فيها. 3) حماية الفرد والمجتمع.[34] 7ـ تحريم اللواط وإيجاب الحد فيه: قال شيخ الإسلام: "وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك، والصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به))[35]، وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال: (يرجم)[36]، ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعه فيه، فرُوي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، وهذه رواية عن ابن عباس، والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيهاً بقوم لوط، فيرجم الاثنان، سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كانا أحدهما مملوكاً والآخر حراً إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ"[37]. 8ـ تحريم القذف وإيجاب الحد فيه: قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْغَـٰفِلَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنـٰتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور:23]. قال ابن كثير: "هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات"[38]. والقذف كبيرة من الكبائر المنصوص عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))[39]. قال الحافظ: "في الآية بيان كون القذف من الكبائر بناء على أن كل ما توُعِّد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حدٌّ فهو كبيرة وهو المعتمد، وبذلك يطابق الحديث الآية المذكورة، وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء"[40]. ولذا شرع الله تعالى الحد في هذه الجريمة حفاظاً على أعراض المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} [النور:4]. قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً، وليس فيه نزاع بين العلماء"[41]. وقال أيضاً: "فأوجب على القاذف إذا لم يقم البنية على صحة ما قال ثلاثة أحكام أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: أنه ترد شهادته أبداً، والثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس"[42]. قال شيخ الإسلام: "ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصناً بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة، والمحصن هنا هو الحر العفيف"[43]. فالقذف فيه جناية على الرجل والمرأة المتَّهمين، وعلى أسرتهما وأقاربهما، وعلى المجتمع بأسره، وفيه طعن في نسب الولد الذي اتهمت أمه بالزنا، لذا جاء الشرع بتحريمه وإيجاب الحد فيه صيانةً لشرف الفرد والمجتمع[44]. [2] شرح الطيبي على المشكاة (6/226). [3] فيض القدير (3/242). [4] صحيح البخاري في كتاب النكاح (9/5) مع الفتح. [5] فتح الباري (9/6). [6] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع الباءة فليتزوج)) (5065). [7] شرح صحيح مسلم (9/172). [8] إحياء علوم الدين (2/75) [9] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء (5073). [10] فتح الباري (9/21). [11] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح ( 5063). [12] فتح الباري (9/8). [13] المغني (9/343). [14] محاسن التأويل (10/224). [15] تفسير القرآن العظيم (4/379). [16] أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب جنين المرأة (6904)، ومسلم في كتاب القسامة (1681). [17] الإملاص: قال ابن الأثير: "هو أن تزلق المرأة الجنين قبل وقت الولادة" النهاية (4/356). [18] أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب جنين المرأة (6905). [19] مجموع الفتاوى (34/161). [20] رسالة في الدماء الطبيعية ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (11/332 ـ 333). [21] مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 276). [22] تفسير القرآن العظيم (3/514). [23] فتح القدير (4/261). [24] أخرجه البخاري في كتاب المناقب، (3508)، ومسلم في الإيمان (61). [25] أخرجه البخاري في كتاب المناقب (3508). [26] أخرجه البخاري في الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (6768)، ومسلم في الإيمان (62). [27] أخرجه البخاري في الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (6768)، ومسلم في الإيمان (63). [28] فتح الباري (6/625). [29] فتح الباري (12/56). [30] جامع مع البيان (15/80). [31] تيسير الكريم الرحمن (ص 456). [32] أخرجه مسلم في كتاب الحدود (1690). [33] مجموع الفتاوى (28/333)بتصرف يسير. [34] حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب ص 42 وما بعدها. [35]أخرجه أبو داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4462)، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي (1457)، وابن ماجة في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (2561)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3745). [36] أخرجه أبو داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4463)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3746). [37] مجموع الفتاوى (28/334-335). [38] تفسير القرآن العظيم (3/287). [39] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب في المحصنات (6857)، مسلم في كتاب الإيمان (146). [40] فتح الباري (12/188). [41] تفسير القرآن العظيم (3/275). [42] تفسير القرآن العظيم (3/275). [43] مجموع الفتاوى (28/342). [44] الإسلام وضرورات الحياة (ص 103-104) بتصرف وزيادة يسيره. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1) المال مال الله استخلف فيه عباده: قال تعالى {ءامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ} [الحديد:7]. قال ابن جرير: "أي: أنفقوا مما خولكم الله من المال الذي أورثكم عمن كان قبلكم فجعلكم خلفاؤهم فيه"[1]. قال القرطبي: "فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة"[2]. فالذي يقع في يده المال وهو يعلم أن المالك في الأصل هو الله وأنه مستخلف فيه فلا ينفقه إلا فيما يرضيه ولا يجمعه إلا من حيث يرضيه، وأن أي تصرف يخرج عما يرضي الله في المال يكون تصرفاً غير مشروع. إن الذي يعلم ذلك ويلتزم بإذن الله في جمع المال وإنفاقه هو الجدير بحفظه، بخلاف الذي يغنيه الله ولا يشعر بهذه القاعدة فإنه يتصرف في المال تصرف السفيه وهو جدير بإضاعة المال وإن ظن أنه يحفظه[3]. 2) الحث على الكسب: قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15]. قال ابن جرير: "وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من مناكب الأرض"[4]. وقال ابن كثير: "أي: فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن ييسره الله لكم"[5]. وقال تعالى: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ} [المزمل:20]. قال ابن كثير: "أي: مسافرون يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر"[6]. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُّ الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))[7]. قال النووي: "فيه الحث على الصدقة والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات بالحطب والحشيش النابتين في موات"[8]. وقال ابن حزم: "وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح"[9]. وقال ابن مفلح: "يسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية، نص عليه في الرعاية"[10]. إن الفرد لا يجب عليه أن يمشي في مناكب الأرض طالباً للرزق، بل يباح له ذلك إلا أنه إذا ترك السعي في طلب الزرق وترتب على ذلك فقره واضطراره إلى سؤال الناس واستجدائهم كان آثماً ووجب عليه حفظ ماء الوجه بطلب الرزق الحلال بكسب يده ما دام قادراً على ذلك، أما ترك الأمة كلها للمكاسب فإنه لا يجوز؛ لأنه خلاف مقصود الله من عمارة الأرض، فالسعي في طلب المال مشروع، وهو وإن كان مباحاً بالجزء فإنه ضرورة بالكل[11]. 3) التزام السعي المشروع في الكسب واجتناب الكسب الحرام: قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ للَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة:172]. قال ابن كثير: "يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة"[12]. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينفقال:{يٰأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيّبَـٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَـٰلِحاً إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون:51] وقال:{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ} [البقرة:172]))، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدُّ يده إلى السماء يارب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيَ[13]بالحرام فأنى يستجاب لذلك[14]. قال النووي: "فيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه"[15]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصَه، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم))[16]. قال القرطبي: "وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام لأنه غير مملوك من المتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، فلو قبلت منه لزم أن يكون مأموراً به منهياً عنه من وجه واحد وهو محال، لأن أكل الحرام يفسد القلوب فتحرم الرقة والإخلاص فلا تقبل الأعمال"[17]. وقال الحافظ ابن حجر: "ومعنى الكسب المكسوب، والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث، وكأنه ذكر الكسب، لكونه الغالب في تحصيل المال، والمراد بالطيب: الحلال لأنه صفة الكسب"[18]. 4) تحريم إضاعة المال: قال تعالى {وَءاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرًا *إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبّهِ كَفُورًا} [الإسراء:26، 27]. قال عبد الله بن مسعود: (التبذير في غير حق وهو الإسراف)[19]. وقال ابن عطية: "التبذير إنفاق المال في فساد أو في سرف في مباح"[20]. وقال تعالى: {وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ} [الأعراف:31]. قال ابن عباس: (أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة)[21]. قال ابن السعدي: "فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفاق"[22]. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع هات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال))[23]. قال النووي: "وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه فساد والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس"[24]. وقال الحافظ ابن حجر: "ومنع منه لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل فوات الآخرة ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم منه. فالحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً فلا شك في منعه. والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاً فلا شك في كونه مطلوباً بالشرط المذكور. والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذّ النفس فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف، والثاني: ما لا يليق به عرفاً وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة فهذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف؛ لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له، وقال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال إ.هـ وقد صرح بالمنع القاضي حسين وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي وتبعه النووي، والذي يترجح أنه ليس مذموماً لذاته لكنه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس وما أدى إلى المحذور فهو محذور"[25]. 5) أداء الحقوق لأهلها: وله أمثلة كثيرة منها: 1ـ أداء الزكاة إلى مستحقيها: قال تعالى {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا} الآية [التوبة:60]. قال ابن كثير: "بين تعالى أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين"[26]. قال ابن قدامة: "ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايا وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى لقوله سبحانه: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء وَٱلْمَسَـٰكِين} و(إنما) للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه"[27]. 2ـ أداء الديون لأصحابها: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ أموال الناس يريدها أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها اتلفه الله))[28]. قال ابن بطال: "فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والتنزه عنها وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل"[29]. وجاء الشرع بتحذير القادر على أداء الدين من تأخيره وجعله ظالماً بالتأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم ومن اتبع على مليّ فليتبع))[30]. قال ابن المنذر: "هذا الخبر يدل على معان منها: أن من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد"[31]. وقال ابن بطال: "وفيه ما دل على تحصين الأموال"[32]. 3ـ تعريف اللقطة: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال: ((عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها))، قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: ((لك أو لأخيك أو للذئب))، قال: ضالة الإبل؟ فتمعَّر وجهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر))[33]. واللقطة هي المال الذي يجده المرء ساقطاً لا يعرف مالكه، فالواجب على واجده أن يعرفه ويعرف الوعاء الذي حفظ فيه من كيس ونحوه، وكذا العلامات التي يتميز بها، ويحفظ هذا المال عنده سنة كاملة يعرف به في المجامع العامة كالأسواق وأبواب المساجد ونحوها فإن جاء من يدعيها وذكر وصفها تاماً أداه إليه[34]. ولها أحكام أخرى كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 6) حماية الأموال من السفهاء: قال تعالى {وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاء أَمْوٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} [النساء:5]. قال ابن كثير: "ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها للناس قياماً، أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها"[35]. قال ابن سعدي: "السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوها، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، ولأن الله جعل الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً، بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً لخواطرهم"[36]. 7) الدفاع عن المال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قتل دون ماله فهو شهيد))[37]. قال النووي: "فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً"[38]. قال ابن بطال: "إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذه الأبواب ليريك أن للإنسان أن يدافع عن نفسه وماله، فإن كان شهيداً إذا قتل في ذلك كان إذا قتل من أراده في مدافعته له عن نفسه لا دية عليه فيه ولا قود"[39]. 8) توثيق الديون والأشهاد عليها: قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ} إلى قوله {وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ} [البقرة:282]. قال ابن كثير: "هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها"[40]. وقال القرطبي: "لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصاً قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها، ورداً على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم وهذا الفعل مذموم منهي عنه"[41]. 9) ضمان المتلفات: قال ابن قدامة: "فمن غصب شيئاً وجب عليه رده... فإن تلف لزمه بدله لقوله تعالى: {فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]؛ ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها من المالية، فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب وجب مثله لأن المثل أقرب إليه من القيمة وإن كان غير متقارب الصفات وهو ما عدا المكيل والموزون وجبت القيمة في قول الجماعة"[42]. ومن القواعد الفقهية قاعدة: الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة[43]. وفي لزوم الضمان على المتلف لمال غيره ضمان من التعدي على الأموال والاستهانة بها، لأن الإنسان إذا علم أنه بغصبه أو بتفريطه في حفظ الوديعة ونحوها من أموال الناس يضمن مثلها أو قيمتها عند تعذر المثلية فإن ذلك يدعوه إلى التحرز والعناية والحفظ والانتباه وعدم الغفلة عنها، فتحفظ بذلك الأموال من الضياع[44]. 10) تحريم السرقة وإيجاب الحد فيها: قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:138]. قال ابن جرير: "يقول جل ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا ـ أيها الناس ـ يده"[45]. قال ابن كثير: "وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أُخر، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح"[46]. قال القاضي عياض: "صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرق كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البنية عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها، وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه"[47]. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، [2] الجامع لأحكام القرآن (17/238). [3] الإسلام وضرورات الحياة (ص133). [4] جامع البيان (12/169). [5] تفسير القرآن العظيم (4/424). [6] تفسير القرآن العظيم (4/468). [7] أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة (1471). [8] شرح صحيح مسلم (7/131). [9] مراتب الإجماع (ص 155). [10] الآداب الشرعية 3(/265). [11] الإسلام وضرورات الحياة (ص 135، 156) بتصرف. [12] تفسير القرآن العظيم (1/210). [13] قال النووي: بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. شرح صحيح مسلم (7/100). [14] أخرجه مسلم في كتاب الزكاة (1015). [15] شرح صحيح مسلم (7/100). [16] أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب (1410)، ومسلم في كتاب الزكاة (1014). [17] المفهم (3/59). [18] فتح الباري (3/327- 328). [19] جامع البيان (15/73) ـ دار الفكر. [20] المحرر الوجيز (3/450). [21] جامع البيان (5/472). [22] تيسير الكريم الرحمن (ص 287). [23] أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى من إضاعة المال (2408)، ومسلم في كتاب الأقضية (1715 ). [24] شرح صحيح مسلم (11/11). [25] فتح الباري (10/422) بتصرف يسير. [26] تفسير القرآن العظيم (2/378). [27] المغني (4/125). [28] أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أدءها أو إتلافها (2387). [29] شرح ابن بطال على البخاري (6/513). [30] أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم (400)، ومسلم في كتاب المساقاه (1465). [31] انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (6/415). [32] شرح ابن بطال على صحيح البخاري (6/416). [33] أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل (2427)، ومسلم في كتاب اللقطة (1722). [34] الإسلام وضرورات الحياة (ص178). [35] تفسير القرآن العظيم (1/462). [36] تيسير الكريم الرحمن (ص164). [37] أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله (2480)، ومسلم في كتاب الإيمان (226). [38] شرح صحيح مسلم (2/165). [39] شرح ابن بطال على صحيح البخاري (6/607). [40] تفسير القرآن العظيم (1/345). [41] الجامع لأحكام القرآن (3/417). [42] المغني (7/361). [43] الأشباه والنظائر للسيوطي (2/2). [44] مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص302). [45] جامع البيان (4/569). [46] تفسير القرآن العظيم (2/57). [47] شرح صحيح مسلم للنووي (11/181). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : صقر الاسلام المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
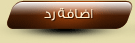 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
 |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
| |
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018